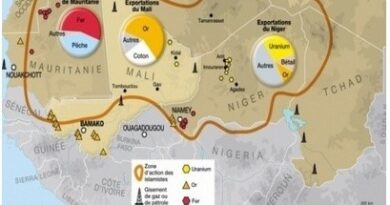الحركة السياسية في موريتانيا دراسة انثروبولوجية تأويلية لملامح التشيؤ والتوتر السياسي بموريتانيا
إعداد:
الدكتور: باب سيد أحمد أعل
عنوان البريد: babemed52@gmail.com
دراسة منشورة في مجلة الأنثربوبولوجيا العدد 16 التسلسلي المجلد 8 العدد 2.
ملخص
كيف ساهمت التنظيمات السياسية في موريتانيا منذ ظهورها أول مرة في تجسيد المعنى الثقافي والاجتماعي الخاص بالمجتمع الموريتاني بما يحمل من رموز وشخوص في الواقع أو الحقل السياسي المعاصر بشكل عام.
وتناولنا الموضوع انطلاقا من محورين الأول نظري ناقش مفاهيم الدراسة (الحركة، والسياسية) ثم نظرياتها المستنبطة من الأنثروبولوجيا السياسية (جورج بلانديه) وما عرضته من نظرية الدينامية القائمة على التوتر والتعارض تبعا لتفاعل مختلف الديناميات الداخلية والخارجية في إحداث التغير السياسي والتوتر والصراع، ثم النظرية التأويلية عند كليفورد غيرتز وما حاولت استنباطه من تأويلات للفعل الاجتماعي ومحاولة لفهم خلفيّاته.
ثم المحور الثاني الذي يتكون من ثلاث فروع حاولنا فيه عرض حاولنا في التعرض للمشهد السياسي الموريتاني من التعددية الكولونيالية إلى تأميم الدولة الشمولية له ثم في زمن الحكم الاستثنائي ثم التعددية المُدمقرطة.
- Study problem:
How political organizations in Mauritania, since their first appearance, have contributed to embodying the cultural and social meaning of Mauritanian society, with its symbols and characters, in reality or the contemporary political field in general.
We dealt with the subject from two axes, the first theoretically discussing the concepts of the study (movement and politics) and then its theories derived from political anthropology (George Blandet) and what I presented from the theory of dynamism based on tension and opposition according to the interaction of various internal and external dynamics in bringing about political change, tension and conflict, then the hermeneutic theory In Clifford Geertz and what I tried to derive from interpretations of social action and an attempt to understand its background.
Then the second axis, which consists of three branches, in which we tried to show we tried to expose the Mauritanian political scene from colonial pluralism to the nationalization of the totalitarian state, then during the time of exceptional rule and then democratized pluralism.
المقدمة
شكلت بداية التأسيس الحزبي بموريتانيا ضمن منافسة التمثيل في البرلمان الفرنسي منتصف أربعينيات القرن المنصرم، فرصة لتشكل وعي سياسي جديد في المجتمع، مما شكل أيضا ميلاد تعاطي مختلف للشأن السياسي مقارنة مع التعاطي الذي كان سائدا قبل ذلك في المجتمعات المحلية، أي أن ملامح باكورة الانتقال من مجتمع أميري تتحكم فيه الولاءات الضيقة للمجموعات القبلية والعشائرية إلى مجتمع وطني تمثلت وتجسدت في تعاطي النخبة السياسية حينها مع الواقع السياسي حسب ما فرضه الدستور الفرنسي من رغبة في تمثيل الدوائر الاستعمارية في البرلمان.
غير أن المعطيات المتلاحقة والتي تلت حدث ذلك الانتقال حتمت التعاطي من جديد مع ذلك الفضاء السياسي وخصوصا مع ميلاد الدولة وفق استراتيجيات مختلفة كاختلاف الأنظمة السلطوية التي تعاقبت على حكم الدولة منذ تأسيسها سنة 1960 من أجل تنظيمها تارة وتارة أخرى من أجل ضبطها وفق الاستراتيجيات الكلية المتبعة من طرف الدولة الوليدة، وهو ما يبعث دوما للتساؤل حول المعنى السياسي والاجتماعي للحركة الحزبية في موريتانيا، أي القيم التي تتمثل وتُجسد في واقع تعاطيها مع الشأن الوطني؟.
من هذا المقام تكون محاولة التأويل الاجتماعي للنشاط السياسي كذلك أنجع للموضوعية في سبيل بناء فهم موضوعي يعيد بناء الحركة السياسية العصرية في موريتانيا ودلالات واقعها وما ينتج ذلك الواقع من رموز وما يستحضر من معاني وقيم خلال رمزيتها تلك وسط واقع سياسي امتزجت به الإدارة العصرية بالذهنية التقليدية وانتجت عمل سياسي يستعصي على المعاصرة بسبب تمثلاته وحلوله في الأصالة أو التقليد، من هذا المقام يمكن أن نفرق ثلاث مراحل أساسية مرت عليها الدولة منذ تأسيسها على المستوى السياسي، مرحلة الحكم الشمولي (تأميم الدولة للمجال السياسي)، ثم مرحلة الحكم الاستثنائي والتي بدأت مع انقلاب 1978، وأخيرا مرحلة الحكم المودمقرط[1].
ومنذ أن ظهرت الحركة السياسية والظاهرة الحزبية بشكل عام في موريتانيا والنخبة تحاول زرع الاستقطاب والصراع فيها أكثر من اعتماد التوافق والتركيز على الملتقيات تجسيدا لقانون (الحظرة[2]) اللامكتوب.
- إشكالية الدراسة:
كيف ساهمت التنظيمات السياسية في موريتانيا منذ ظهورها أول مرة في تجسيد المعنى الثقافي والاجتماعي الخاص بالمجتمع الموريتاني بما يحمل من رموز وشخوص في الواقع أو الحقل السياسي المعاصر بشكل عام.
- تفريعات الإشكال.
- ما هي دوافع ظهور الحركة السياسية بموريتانيا؟.
- كيف واءمت بين التحديث والتقليد على مستوى الممارسة والقيم؟.
- ما دواعي التوتر والتعارض والصراع.؟
- ثم كيف نبني معنى مستقلا لذلك التوتر والصراع؟
- فرضيات الدراسة
الفرضية الأول: الحركة الحزبية السياسية ولدت كردة فعل تتطلع لخلق بديل سياسي وقيادي لزعامات التقليدية.
الفرضية الثاني: لم تولد الحركة السياسية بموريتانيا إلا من أجل بناء الدولة وتنشيط المجموعات الاجتماعية في هياكلها.
- مفاهيم ونظريات
نقسم هذا المحور بين تأصيل المفاهيم وبحث النظريات أي فحص الأساس الذي يحدد معالم التوجه العام للدراسة، على ذلك الأساس سنهتم بفرع المفاهيم والبحث فيه ثم النظريات من أجل رسم معالم توجه موضوعي لهذه الأسطر.
- مفاهيم الدراسة:
سوف نعتمد في هذا المقال مفهومين أساسين، هما مفهوم الحراك، ومفهوم السياسية باعتبار أنهما العمودان المكونان لبنية هذه الدراسة التحليلية.
- مفهوم الحراك:
الحراك أو الحركة الاجتماعية تعني في اللغة العربية: “حركَ حَرْكا بالفتح، وحَرَكَةٌ ضد سكن (الفيروز أبادي ، 2008)” وضد السكون والثبات وهو ما يعني أن الحراك يدل في اللغة على عدم الثبات والسكون، غير أن تجاوز البعد اللغوي البحت إلى المعنى الاصطلاحي المركب قد يجعلنا أمام دلالات ومعاني لا تختلف إلا لتتفق على جزئية من الدلالات المطلوبة واقعيا لكل من الحراك في أصله ومفهوم الحراك في اصطلاحه.
ينظر “لورانز ستاين” للحركات الاجتماعية في كتابه “تاريخ الحركة الاجتماعية في فرنسا من 1789 إلى 1850” كمفهوم للإشارة إلى محاولات البروليتاريا اكتساب القوة الاقتصادية والسياسية متفقا في ذلك إلى حد كبير مع كارل ماركس (محمد سفيان، 2019-2020).
النظرة الأولي على هذه التعريفات المقتضبة للحركات الاجتماعية، يجعلنا نخرج يقينا من حرج اللبس أو الخلط بين الحركات الاجتماعية والحراك الاجتماعي معتبرين في ذات الوقت أنهما وإن تقاربا في الأصل اللغوي فإنهما تباعدا في الدلالة وما تعنيه، لذلك فإن مبعث الحركات الاجتماعية قلق وغايتها ترسيخ عقيدة وقيم جديدة، أما المجال الاجتماعي الذي تتحرك فيه فإنه الأرضية التي من خلالها تُصاغ هيئة “الحركات” وطبيعة تعاطيها مع المجتمع وفاعليه أو السلطة وحاكموها.
وهذا قريب جدا في مجمله من تعريف الحركات الاجتماعية في موسوعة علم الاجتماع حيث تعرف على “أنها الجهود المنظمة التي يتم بذلها من قبل مجموعة من الناس المؤثرين بهدف تغير (أو مقاومة تغير) جانب ما أو أكثر من المجتمع وتختلف هذه الحركات عن السلوك الجمعي في كونها هادفة ومنظمة في حين أن ذلك السلوك يكون ارتجاليا وغير محدد الهدف وتصنف أهدافها بأنها قد تكون أهداف محدودة وواسعة، وقد تكون ثورية أو إصلاحية، وتضيف الموسوعة بأن الحركات الاجتماعية تأتي في شكل تنظيمات رسمية وتتسم بالاستمرارية والعمل خارج القنوات السياسية المعتادة والقدرة على تعبئة الجمهور حول مشروع محدد التغير” (جمال رشاد عرفات ، 2017).
إن دلالة الحركة اللغوية باعتبار أنها ضد الثبات، لا تختلف كثيرا عن المعنى الاصطلاحي بما يوحي إليه من عدم استقرار وجموح نحو التغير بطلب هدف معين وفق تنظيم يتطور حسب الظروف المحيطة بمختلف الأوجه، إما أن يكون جزءا من التغير الكلي ويرتبط بهوية نواة الحركة الأولية، وإما أن تكون محاولة تنتج عنها تفريعات لمحاولات حركية أخرى تصطدم بالواقع من نواحي عديدة يتلاقى فيها النفسي مع الاجتماعي تحت يافطة تنظيم معين.
- السياسة، المفهوم والدلالة
جاء في لسان لابن منظور أن السياسة مصدر للفعل ساس يسوس، وساس الأمر سياسة قام به وسوسه القوم جعلوه يسوسهم، ويقول الفيروز أبادي – صاحب القاموس المحيط- سست الرعية أي أمرتها ونهيتها، وقال بن حجر: يسوس الشيء أي يتعهده بما يصلحه (مكاوي ، 2018).
أما مصطلح السياسة في اللغات الغربية ومنها الإنجليزية (politics) والفرنسية (politiques) فهو مشتق من ثلاث كلمات لاتنينية، polis وتعني المدينة، وقد كانت المدينة هي الوحدة السياسية في اليونان القديمة حيث عرفت اليونان أنذلك ما أطلق عليه دولة المدينة (state- city)، و politica وتعني الأشياء السياسية والمدنية النظرية وكل ما إذا ذكر تبادر إلى الذهن معنى السياسة كدستور والسيادة وغيرهما من الكلمات، وpolitika وتعني السياسة كفن وكممارسة يقوم بها السياسيون.
فإذا كان من الناحية الاصطناعية مصطلح “السياسية” يعني في اللغة العربية الفعل وتدبير الفعل بما يحمل من أمر ونهي وقيادة، فإن تشعبات المعنى في اللغات الأجنبية ما بين وحدة المدينة السياسية ومحمولات الأشياء السياسية فضلا عن الممارسة كفن يكتسيه نوعا من الغموض في إطار تعدد الدلالات، خصوصا وأن الاشتغال في مجال السياسية من الناحية المعرفية تتجاذبه عدة حقول وتخصصات ما جعل إشكالية الحفر تتطلب فضلا عن تبين دلالات المصطلح إيضاح تلك المجالات في اشتغالاتها.
ومن الناحية الفكرية تتجاذب مصطلح السياسة أربعة اتجاهات، الاتجاه الأول منها وهو الاتجاه قديم برز في كتابات اليونانيين القدماء من أمثال سقراط وأفلاطون ، حيث يرى سقراط 467- 399 ق م أن السياسة هي فنّ الحكم والسياسي هو الذي يعرف هذا الفن، وبالتالي فإن السياسة عند سقراط هي (فن) يتفاوت الناس في كسبهم منه، فمنهم السياسي البارع الذي يجيد هذا الفن ومنهم من لا يجيده، بينما يرى أفلاطون ( 428- 347 ق م) أن السياسة هي فن حكم الأفراد برضاهم والسياسي هو الذي يعرف هذا الفن.
الاتجاه الثاني يرى أنصاره أن السياسة هي صراع مستمر بين الأفراد والجماعات من أجل الوصول إلى السلطة فقد قال هانز مورجشا (1904- 1980) أن السياسة هي مجال السلطة والعمل السياسي هو الكفاح من أجل القوة، بينما يرى ميكافيللي (1469- 1527) أن السياسة ما هي إلا معركة، بل هي معركة مستمرة تتمثل في الصراع على القوة، وكذلك يرى أغلب الاشتراكين أن السياسة تعني الصراع فعلى سبيل المثال يعرفها تروتسكي على أنها النشاط الاجتماعي المرتبط على نحو وثيق بالكفاح من أجل السلطة، وهي عند جورج كلاوس، صراع بالدرجة الأولى بين الطبقات حول السلطة الاقتصادية والدولية بهدف استخدام سلطة الدولة لتخفيف المصالح الطبقية، وصيانتها والدفاع عنها.
أما الاتجاه الثالث في فيستخدم مصطلح السياسة على أنه السعي للسلطة من أجل بسط النفوذ، وهناك اتجاه رابع يعرفها على أننها فنّ الخداع، أي فنّ حكم البشر عن طريق خداعهم.
علاوة على ذلك لا يمكن إهمال الجانب القانوني والاجتماعي ودلالتها في مفهوم السياسية تداخلا وتعبيرا، حيث يعتمد تعريف علم السياسة أساسا على الموضوع المحوري والذي يعتبر مادته الأساسية ويرتبط هذا التعريف بمنظورين أساسين: منظور ذو طبيعة قانونية وقوامه مفهوم الدولة ومنظور ذو طبيعة سوسيولوجية يتمحور حول مفهوم السلطة وبهذا يكون تعريف علم السياسية موضوع منظورين متجاذبين (فقهي ، 2014-2015).
بناء على ذلك يمكن تعريف السياسة في إطار العلاقة التي تجمعها بمفهوم الحراك على أنها الحركات في طبيعتها التنظيمية قد تكون ذات دلالة سياسية وهو ما نركز عليه في هذا المقال فتسمى حركات سياسية تتجاذب في تقاطعات أهدافها السعي للسلطة والنفوذ والقوة، وتعمل بمقتضى قواعد الفن السياسي والقيادة، وقد تكون ذات طبيعة مختلفة عن أغراض السياسة أيضا، وهو النادر جدا نظرا لشمولية المعنى السياسي وتزاحمه مع مختلف الحقول والقارات المعرفية والاشتغالية.
- النظرية السياسية من التضارب إلى المعنى
سنحاول من أجل الوقوف على المصالح التي تحرك التنظيمات والحركات السياسية في الغالب وما يعترضها من تعارضات وتوترات على منهج التحليلي لـ “جورج بلانديه” في ذلك علاوة على البحث في المعنى الاجتماعي وتأويله على النظرية التأويلية التي نظّر لها “كليفورد غيرتز”.
- التوتر والتعارض عند بلاندييه
يحاول جورج بلانديه أن يعطينا صورة أولية في كتابه “الآنثروبولوجيا السياسية” عن المنهج الدينامي باعتباره منهجا سياسيا بامتياز لأنه يركز على التوترات والتناقضات وتلك تظهر أكثر في ميدان السياسية كما يرى “أن المنهج الدينامكي الذي يتبنى يتناول دينامكية البنى وكذلك نظام العلاقات التي تكونها، أي التعارضات والتناقضات والتوترات والحركة الملازمة لكل مجتمع، ويفرض هذا النهج نفسه كأنثروبولوجيا سياسية خصوصا وأن الميدان السياسي هو الميدان الذي نلتقط فيه هذه التعارضات والتناقضات والتوترات بشكل أفضل والذي يترك فيه التاريخ بصماته بأوضح ما يكون” (بلاندييه ، 2007).
يقدم بلانديه المنهج الدينامي على أنه لا يدخل إلا في مجال الصراعات السياسية وما تفرضه من توتر وتعارض حسب بلانديه أو تمرد الذي يوازي النظام وهو جزء من السيرورة التاريخية السياسية حسب غلوكمان، هو بشكل عام ينظر إلى الواقع السياسي في المجتمع وما يتخلله من نزاع وتعارض وتمرد وتوتر.
جورج بلانديه الذي ربط التحليل الدينامي بالسياسة يرى أن الظواهر السياسية ستشكل العقبة الأساسية عند ما نعتقد أنها تتميز بشكلها التركيبي (أنها تختلط بتنظيم المجتمع العام) وبديناميتها، فهي تعتمد على عدم المساواة والمنافسة، ولكي تكون النماذج الضرورية لتصنيفها ملائمة يجب أن تكون قادرة على التعبير عن العلاقات بين العناصر المتغايرة وعلى تحليل الدينامية الداخلية للأنظمة، يعني أن هذا التحليل لا يعني الفصل بين السياسي والاجتماعي بل إن فهم التناقض والتعارض الذي يظهر في المشهد السياسي يتطلب فهما أعمق للمستوى الاجتماعي الذي يعتبر أرضية حضنه الخصبة.
ما يميزُ بلانديه أن دراساته استهدفت المجتمعات الإفريقية مركزا على التغيرات التي أحدثتها القوى الاستعمارية في هذه الشعب نتيجة لالتقاء عوامل داخلية وخارجية متعددة ومتاشبكة في بيئة سياسية واجتماعية واحدة، حيث يرى في تشكيل نظريته الدينامية أن الاستقلال في الشعوب الإفريقية أحدثت دينامية جديدة في التقليد حسب توجه مزدوج، فمن جهة حرر القوى التي كانت مكبوحة أثناء الفترة الاستعمارية، كما تبين ذلك من عدة أزمات حصلت خلال السنوات الأخيرة والتي تنم عن انبعاث الخصومات القبلية أو الدينية، ومن جهة أخرى لم يكن بإمكان النشاط السياسي الحديث أن ينتظم وأن يعبر عن نفسه إلا باعتماده على تقليد حقيقي من جديد تصبح النماذج والرموز التقليدية وسائل الاتصال والتعبير التي يعتمد عليها المسؤولون في توجيههم إلى الفلاحين السود.
- التأويل الثقافي عند غيرتز
رمزية غيرتز تنطلق من محاولة تفكيك دلالات الثقافة ورمزيتها أو تعريفها من خلال إيحاءاتها الرمزية، حيث يقول تبعا لذلك “إن مفهوم الثقافة الذي اعتنقه هو بالأساس مفهوم سيميائي وأنا مقتنع مع ماكس فيبر أن الإنسان هو حيوان عالق في شبكات رمزية نسجها بنفسه حول نفسه، وبالتالي أنا انظر إلى الثقافة على أنها هذه الشبكات وأرى أن تحليلها يجب أن لا يكون علما تجريبيا يبحث عن قانون بل علما تأويليا يبحث عن معنى” (غيرتز، كليفورد، 2009)، وبذلك يتحدد التوجه الرسمي لنظرية غيرتز التأويلية الذي يبحث عن معنى الإيحاءات والتفاعلات والأفعال ذات المعنى الثقافي.
وليس هذا فحسب بل إن طبيعة تحديد الهدف بالتفصيل أو التفريق بين المعنى والقانون، حاول غيرتز أن يُبين عمل المفكر أو الانثربولوجي من خلاله النظر في ممارسته وبل السماع عنه من غيره حيث اعتمد غيرتز حسب ما يصرح به في كتابه “تاويل الثقافات” على دراسة “جيلبرت رايل” تظهر في مقالتين حديثتين له حاولت معالجة أو تفسير ما يفعل المفكر ذلك أن غيرتز يعتبر أن معرفة أي علم لا يمكن أن تتم بالإصغاء إلى المدافعين عنه بل في دراسة نظريات وأعمال الممارسين له، لذلك فإن مهمة الانثروبولوجيا عنده تتمثل في التحليل الاثنوغرافي، ولذلك فإن غيرتز يعتمد على مسألة التوصيف الكثيف الذي اعتمده رايل في دراسته ويعالج التوصيف الكثيف ما يفعله المفكر انطلاقا من المقالتان “التفكير والتأمل وتفكير التفكير”.
إن الفرق الذي يريد غيرتز الوصول إليه من خلال فكرة رايل عن تفكير التفكير أو التوصيف الكثيف هو الفرق بين الفعل الثقافي الذي له معنى مهما كان معناه أو دلالته من خلال الغمز والحركة السلوكية الطبيعية، وقياسا على التوصيف الكثيف يصل غيرتز على أن الكتابة الانثربولوجية تبقى ناقصة إن لم تنتقل من الوصف إلى التحليل والتفسير انطلاقا من مبدأ الرمزية أو رمزية الغمز ودلالة شفرته.
- الحركات السياسية في موريتانيا
إن التعرض للحركة السياسية على اعتبار أنها نتاج الفهم المعاصر للدولة الحديثة، وآلية تنظيمية من اجل خلق تغيير وتقوية الفاعلية والمشاركة السياسية في السلطة وفي تسير الشؤون العامة للبلاد في مجتمع كالمجتمع الموريتاني يتطلب التركيز على ما نتعقد في سياق التأسيس والتأميم، ثم الحركة والتعدد، فضلا عن المعنى الاجتماعي الذي كانت هذه الحركات السياسية تهدف دوما في اللاشعور واللاوعي لاستحضارها في الواقع المعاش.
- من التأسيس إلى التأميم .
كانت أولى بوادر ظهور الحركات السياسية في منتصف أربعينيات القرن 20 المنصرم، إثر قانون جديد أعلنت عنه السلطة الفرنسية في مستعمراتها لغرض تمثيلهم في البرلمان الفرنسي، ثم الحركة السياسية (الحزبية) في التشعب بعد إجراء أول انتخابات تمثيلية عن إقليم البلد إلى غاية الاستقلال وإعلان تأسيس الدولة.
- السياق السياسي القبلي لتأسيس الدولة
حيث ورد في دستور 1946 الفرنسي الذي أعلن عنه الجنرال ديغول أن فرنسا عازمة على قيادة الشعوب المسؤولة عنها نحو حرية إدارة نفسها بنفسها وتسير شؤونها الخاصة بصفة دمقراطية”، (ولد أباه و وآخرون، 1995) الأمر الذي فتح الباب واسعا لخلق كيانات سياسية متفاوتة الرؤى والأهداف دخلت في عمق صراعها وتوتراتها فرنسا الساعية إلى تغير ضمن السياق العام لسياساتها في أقاليمها المستعمرة.
إن محاولة دراسة المجتمع حسب التطور الكرو ولوجي للأحداث وقياس مدى فاعلية النتائج الملاحظة أو المستخلصة من جملة المتغيرات التي طرأت على المجتمع أو أدخلت عليه بفعل عامل الاستعمار الفرنسي، وما تمليه تلك العوامل الجد العميقة على واقع اجتماعي شبه راكد يرفض التغير من الخارج دوما، وحسب آليات ووسائل اقتصادية وثقافية باتت تفرض نفسها بفعل عوامل عدة، أمر من الصعب ضبطه أو السيطرة عليه بفعل كثافة المعلومات والشواهد المستخلصة من جهة، ومن جهة أخرى بفعل بطئ التطور وفجائية الأحداث السياسية التي تلاحقت بعد قانون 1946م.
فقد أوضح دي شاسه أنه برز اتجاهان أساسيان منذ عام 1946م، سماهما الاتجاه التقدمي والاتجاه المحافظ، وإن كان المحتوى لكل واحد منهما ضبابيا وغير منسجم وفي بعض الأحيان غامضا فعلى هذا النحو، أي على أية حال يتحدد الواحد منهما بالنسبة للآخر.
يتميز الاتجاه التقدمي بعدائه للسلطة الاستعمارية وللزعامات التقليدية، فأعلن منذ البداية تطورا سريعا للوضع الاستعماري وللنظام الاجتماعي التقليدي الذي يحافظ عليه، وقام ابتداء من عام 1957 بحملة من أجل الاستقلال الفوري عن المجموعة ومن أجل القضاء الفوري على الاسترقاق والطبقية.
أما بالنسبة الاتجاه المحافظ فإن هذه المتطلبات غير معتبرة إطلاقا ويدعو إلى الحفاظ بالوضع الحالي ثم بعد ذلك إلى تطور بطيء ومحسوب في اتجاه استقلالية السياسة ولكن بدون قلب للنظام التقليدي ودائما في إطار الإخلاص ثم الصداقة مع فرنسا (دي شاسيه ، موريتانيا من سنة 1900 إلى سنة 1975، 2014).
تأسس الاتجاه التقدمي على خلفية فوز رمزه حرمه ولد ببانه في أول انتخابات تشريعية أجرتها فرنسا في دائرة الإقليم الموريتاني 1946، كنائب عن موريتانيا في البرلمان الفرنسي كأول ممثل لموريتانيا في البرلمان الفرنسي (ولد أباه و وآخرون، 1995) ويشكل ذلك الفوز أول توتر بين النخبة التقدمية المعادية للمرجعيات الاجتماعية التقليدية والشيوخ الذين دعمتهم فرنسا كقوة محافظة معارضة للحركة السياسية التقدمية بعد أن هزم حرمه ولد ببانه مرشحهم “افون رزاك” في أول انتخابات بموريتانيا.
غيرت فرنسا سياسة ترشيح شخص من الخارج وقررت دعم النخبة القبلية في مواجهة الحركة الوطنية التقدمية، وعلى ذلك الأساس ظهر تحالف سياسي مدعوم من الإدارة الفرنسية اتخذ اسم الحزب التقدمي الموريتاني الذي عقد مؤتمره التأسيسي في مدينة روصو في شباط/فبراير 1948 بحضور العديد من الزعامات التقليدية بالإضافة إلى أغلب أفراد سلك المترجمين الذين يشكلون طبقة محظية لأنهم هم الوسطاء بين محتلي الدولة الفرنسية والسكان المحلين، وفي الفترة ذاتها تأسس حزب الوفاق الذي تزعمه النائب حرمه ولد ببانه وعمل من خلاله على تعبئة القطاعات الشعبية المؤيدة إياه وتنظيمها، واستطاعت الحركة أن تحافظ على الفوز على تقدمية حزب الوفاق في انتخابات 1951 وأدخلت مرشحها سيدي المختار انجاي البرلمان الفرنسي خلفا لولد ببانه، وبقيت الحركة السياسية تتطور بتجاذبات الحركتين إلى غاية حصول الدولة على الاستقلال الوطني.
- الدولة وتأميم المجال السياسي
خرجت الدولة من رحم تلك الرؤية الحزبية المزدوجة، وربما تفاقمت في إطار التشكيك في الكيان ذاته وتعبيته لدول الجوار، (مالي – المغرب)، وهو ما جعل منطق السلطة الجديدة ورؤيتها حول هوية أو طبيعة الحركة السياسية تتغير تبعا، لتلك الازدواجيات المتعددة.
كانت أولى خطوات السلطة الجديدة للدولة المستقلة على المستوى السياسي هو إنشاء حزب الشعب بديسمبر 1961م وضم مختلف الأحزاب والفاعلين السياسيين فيه، محاولة إضفاء الطابع المؤسسي عليه (jean louis) كحزب وحيد للدولة والقضاء على التعددية التي أقرتها الإدارة الاستعمارية سابقا وتعاملت مع النخب السياسية بمقتضاها، فكان ذلك الإجراء بمثابة أول ملامح التوجه السياسي الجديد للسلطة الجينية التي تسير البلاد.
وهو ما يمثل تقيضا للحركة الحزبية وتوجها للمثال الشمولي للدولة، من أجل تجاوز مختلف العقبات وفي مقدماتها تشكيك الكثير من النخبة التي كانت تمثل طلائع التقدمين المناهضين للاستعمار في شرعية كيان الدولة ذاتها من جهة، ومن جهة من أجل تجاوز العقلية الاجتماعية التي تفتقر للشروط الحزبية من أجل خلق كيان وطني قبل ذلك.
هذا التأميم الحزبي والسياسي والانجرار للطابع الشمولي للدولة بالاعتراف بحزب وحيد للسلطة هو المسير لها، أدى إلى خروج مبكر للحركة الحزبية من إطاراتها التنظيمية، وانبثاقها من جديد في ثوب الحركات الإيديولوجية غير الحزبية تأثرا بظروف العالم العربي وما يشهد من حركات قومية وبالعالم الغربي بما يشهد من صراع بين الرأس مالية والاشتراكية.
- الحركة اليسارية : كانت أول ردة فعل على الإيديولوجية الرسمية التي تبنتها الدولة هي إضراب العمال في مدينة ازويرات سنة 1968 حيث أضرب (من 600 إلى 800 عامل من أصل 2000 حسب التقديرات) بسبب تدني الأجور وعدم انتظام دفع العلاوات المقررة ، بالإضافة إلى عدم احترام القوانين المعمول بها في مجال الإجازات والمكافآت والطرد من الوظيفة والسياسات التميزية المتمثلة في اكتتاب عمال أجانب أوروبيين وأفارقة (دي شاسيه ، موريتانيا من سنة 1900 إلى سنة 1975، 2014)
- الحركة القومية: وقد برزت بوادر الاتجاه القومي العربي ممثلا في (الوفاق الموريتاني والشبيبة الوطنية وحركة النهضة)، في حين كان الاتجاه القومي الزنجي ممثلا بمنحدري ضفة النهر وكتلة غورغل، وقد شهد هذا الاتجاه مراحل مد وجزر تبعا لمتغيرات محلية وعربية ودولية، كما عرف تسميات متعددة بدأت بنقابة المعلمين العرب ، مرورا بحركة القومين العرب وصولا إلى الحركة القومية التي انقسمت فيما بعد إلى تيارين أحدهما ناصري والآخر بعثي لا يختلفان إلا في بعض التفاصيل الجزئية(حرمه ببانا العلوي، 2014).
وكان أول ظهور للحركة الناصرية بشكل مستقل في صيف عام 1975 ، تحت اسم “التنظيم الوحدوي الناصري في موريتانيا” وقد تمكن هذا التنظيم من خلق جناح له في الجيش كان يهيئه لإحداث تغيير في البلاد إلا أن الظروف المحلية التي رافقت انطلاق نشاطه التنظيمي ومنها الحرب في الصحراء وعودة موريتانيا إلى تحالفها السابق مع فرنسا حدَّ من تأثير ذلك.
أما الجناح القومي الثاني وهو الجناح البعثي فعلى الرغم من رسوخ قيمه وأفكاره في المجتمع الموريتاني إلا أن أول كيان تنظيمي بعد الاستقلال ظهر له هو “الطليعة العربية الثورية” 1975، وعلى الرغم كذلك من كونه تعرض لخلافات حادة بين مكوناته إلا أنه استطاع أن يكون تنظيما خاص أشرف على اختيار قادته أحد أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي وهو الدكتور قاسم سلامي (من اليمن) واختار محمد يحظيه ولد الطلبة على رأس التنظيم ، واستطاع التنظيم أن يرتبط بقيادة البعث المركزية عن طريق التقارير الشهرية التي يرسلونها عن البعث في موريتانيا (حرمه ببانا العلوي، 2014).
- الحركة الإسلامية: مرت الحركة الإسلامية في موريتانيا بوصفها تجسيدا لتيار الوعي الإسلامي بأحداث وتطورات كثيرة شهدتها الساحة السياسية ، كما تجاذب على مسارها الفكري رؤى وتوجهات متباينة ، فعلى مستوى مسيرتها مرت الحركة بمرحلتين:
- في مرحلتها الأولى تعايشت فيها مع السلطة بسلام بل وانسجام في كثير من الأحيان وتبدأ هذه المرحلة من 1975 تاريخ بداية الحركة بموريتانيا إلى سنة 1993.
- المرحلة الثانية كانت مرحلة اصطدام مع السلطة وهي المرحلة التي بدأت من سنة 1993 بموجة من الاعتقالات في صفوف الحركة بتهمة تهديد الأمن
وعلى مستوى التنظير الفكري فالتيار الإسلامي في موريتانيا يصنف أنه محكوم بتوجهين فكرين هما:
- الاتجاه السلفي بشقيه التعليمي (التقليدي) والجهادي
- الاتجاه التجديدي (الإخواني) وهي المجموعة التي ترفع شعار الموازنة بين الثوابت والمتغيرات وهي متأثرة بالحركات الإخوانية التجديدية(حرمه ببانا العلوي، 2014)
يمكن القول أن هذه الحركات التي ظهرت في المجال الفكري والسياسي الموريتاني هي التي أطّرت العقل السياسي الحديث لموريتانيا وانبثقت منها أو من منطلقاتها الفكرية ورؤاها الحركة الحزبية بتعددها وكثافتها وتضاربها، علاوة على ذلك فإن دساتير البلاد كلهم حاولت المزج بين الانتماء الإفريقي والهوية العربية الإسلامية.
وكانت السلطة في مراحل تغيراتها المختلفة بموريتانيا، من النظام الشمولي إلى النظام الاستثنائي[3] أقرب إلى الحركة القومية لأنها حاولت أن تتغلل إلى السلطة، وتبعد عن الحركة الإسلامية التي تصفها بالمتطرفة، والحركة اليسارية التي تصفها بالكفر والإلحاد، وبقيّ الحال الحركي كما هو عليه مضمرا، ومعلنا إلى أن تمت شرعنة التعددية الحزبية من جديد في دستور 1991، وتسربت هذه الحركات في تنظيمات حزبية مختلفة تنافس على السلطة والمؤسسات التشريعية في البلد.
لا ننسى أنه في الإطار الحركي دوما تأسست “حركة الحر” في 5 مارس 1978 وقد حاولت حركة الحر من خلال وثيقتها التأسيسية التي بين أيدينا أن تبني نضالها على قراءة شاملة للحراطين، فعرجت على المشكل العقاري في مجال الزراعة وما يتعرض له الحراطين بوصفهم فلاحين وهم عصب الزراعة مطالبين بإصلاحها من أجل النهوض بالقطاع الزراعي، كما جاء فيه أنهم في حركة الحر سيحاولون النضال من أجل القضاء على العمالة المنزلية والمنشغلين في رعي المشاية أيضا، وعرجوا في الوثيقة على التعليم معتبرين أنه صُمم من أجل منع ترقية الحراطين بالقضاء على التميز المستخدم ضد الحراطين في المدارس الابتدائية والثانوية والعالية ( “el hor”).
- التعددية وسياقات التضارب
بدأت هذه المرحلة مع اعتماد دستور 1991 الذي أقرّ التعددية الحزبية في ظل حكم الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع، والتي انتهت من خلالها مرحلة الحكم الاستثنائي وجاءت مرحلة الحكم المودمقرط مع دستور 1991 الذي جاء في ديباجته أن الإسلام هو المصدر الوحيد للقانون كما تم استلهام مبادئ الليبرالية فيه مثل مفهوم (سيادة، قانون الاقتراع، فصل السلطات، الحقوق والحريات الفردية وكذلك نص على سيادة القانون) (ولد سيدي باب و محمد الأمين ، 2019) والذي عادت معه تلك الحركات السياسية إلى بناء تنظيماتها الحزبية، علاوة على ما اعترى أطر الحركات الإيديولوجية في ظل تضارب وصراع الجيش على السلطة من اختلافات تحددت من خلال دخول بعضهم في معسكر السلطة ومغاضبة البعض له، أو محافظته على جزء من انتماءه الإيديولوجي في بعض الأحيان ونتيجة لتأثير السلطة ذاتها بهذه الحركات الإيديولوجية المختلفة المشارب والمقاصد.
إعادة فتح الباب أمام الأطر والساسة لتشكيل الأحزاب والمنظمات بعد أن انقضت فترة الاحكم الشمولي بانقلاب 1978م، وبعد أن انقضت كذلك فترة الحكم الاستثنائي بانتخابات 1992م الرئاسية، أعاد إلى السطح الصراعات الحركية السياسية والحزبية التي طبعت الساحة بتطور التنظيمات الحزبية منذ نشأتها، واختلافها وتضاربها وتصارعها في أغلب الأحيان نتيجة لتضارب رؤى القادة والأطر السياسيين نفسهم.
وفي يوليو 1991 أصدرت اللجنة العسكرية للخلاص الوطني أمرين قانونيين يتعلقان بحرية تشكيل الأحزاب وبحرية الصحافة، بينما وضعت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 الضوابط القانونية والإجرائية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وبالنواب وأعضاء مجلس الشيوخ، وفي الشهور الأخيرة من السنة ذاتها 1991 تشكلت أحزاب سياسية بلغ عددها في نهاية 1994 سبعة عشر حزبا سياسيا معترفا بها كان أغلبها تشكيلات هشة وصغيرة لا موقع لها في الخارطة السياسية الموريتانية (ولد أباه و وآخرون، 1995) لأن الدستور المصادق عليه لم يحدد عددا معينا للأحزاب في الدولة.
استشراف الجديد كان الجميع ينتظره بشغف، حيث حاولت جماعات سياسية عديدة باستحياء التنبيه إلى ضرورة نهج في الحكم يقطع كل صلة مع التجارب الماضية واستخدموا المنابر، وبعد خطاب 15 ابريل 1991 الذي أعلن فيه الرئيس ولد الطايع بدء مشروع دمقرطة الحياة السياسية في موريتانيا قامت جماعات سياسية عديدة بنشر بيانات أوضحت من خلالها موقفها من المشروع الديمقراطي، من هذه الجماعات “الجبهة الديمقراطية الموحدة” وذلك في بيان صادر يوم 5 يونيو 1991، وكذلك الحركة الإسلامية “حاسم” في بيانها الصادر شهر يونيو 1991 حيث طالبت هذه الحركة بإقامة تعددية حزبية حقيقية تفسح المجال أمام مشاركة جميع القوى السياسية وأكد البيان أن حل المشكل السياسية هو المطلب الجمهوري (ولد سيدي باب و محمد الأمين ، 2019)
هذه البيانات كانت تعبر من خلالها الحركات السياسية التي أخمد إطارها التنظيمي الحكم الشمولي والاستثنائي عن رغبتها في التواجد في الساحة السياسية ضمن إطارات قانونية تسمح لها بالمشاركة والمنافسة، بدل حالة اللاعتراف والصدام الذي كانت تعيشه في ظل تينك الحقبتين ،الأمر الذي سمح بظهور العديد بل والكثير من الأحزاب طوال تلك السنوات التي عقبت دستور 1991، وكان أغلبها أحزاب لا موقع لها في الساحة السياسية أو كما هو رائج عن وصفها بموريتانيا (احزاب الورق)، ورغم ذلك فإن تعامل السلطات معها وكذلك النخبة الحاكمة كان له دور في المحافظة عليها في إطار شرعنة مصطلح الأغلبية على الموالاة دوما بانضمامها تحت لواء أحزاب الأغلبية الحاكمة.
يقدم السيد ولد أباه في دراسته “الدولة والقوى السياسية” عدة تسميات حزبية كانت الأكثر فاعلية في فترة الانفتاح التعددي بعد دستور 1991، هذه الأحزاب التي كانت منبثقة من حركات سياسية أو لها طابع خاص (تستند على السلطة) كانت هي الأكثر رواجا والأكثر فاعلية في الحياة السياسية، هذه الأحزاب هي الحزب الجمهوري الديمقراطي الذي يرأسه الرئيس معاوية ولد الطايع[4] أنذاك، وحزب اتحاد القوى الديمقراطية الذي يمثل حزب المعارضة الرئيسي، ويضم تحالفا من الحساسيات والقوى السياسية المناوئة للنظام من مواقع وخلفيات مختلفة، ثم حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم ويتقدم بوصفته حزب المعارضة الوسيطة ويرأسه الوزير الأسبق في عهد المختار ولد داداه حمدي ولد منكاس ويضم عدد من رموز حكم ولد داداه، بالإضافة حزب التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة ذو التوجه الليبرالي الوسطي، وحزب التحالف الشعبي التقدمي الذي هو امتداد للاتجاه القومي الناصري، ثم حزب الطليعة الوطنية المكون من القومين والبعثين.
تشير المعطيات على أن أوجه التضارب كانت جلية في حزب اتحاد القوى الديمقراطية الذي يضم عدة حركات إيديولوجية واجتماعية مختلف وجل ما يجمعها هو معارضة السلطة الحاكمة، بدأت ملامح تضاربها تطفو على السطح من خلال، موقف الكثير من جبهة التغير من ترشح مسعود ولد بلخير الذي كان أمينا عاما للحزب بحجة أن الرئاسة لا يمكن أن يترشح لها حرطاني، وقرروا بدلا من ذلك وبعد مغاضبة قادة الحر في الحزب ترشيح أحمد ولد داداه (ولد عبد الرحمن ، 2019) شقيق الرئيس الأسبق المختار ولد داداه، والذي يرأس حاليا حزب تكتل المنبثق عن نفس الحزب.
وبعد مغاضبة قادة الحر بسبب استبعاد ترشيح رئيسهم وتزكيته من قبل الحزب الأبرز للمعارضة انسحبوا ثم عادوا بعد حوار واتفاق بينهم مع المعارضة، هذا التوتر في أقوى أحزاب المعارضة لم يكن الأخير فقد عقبه انسحاب مجموعة حمدي ولد مكناس ومحمذن ولد باباه التي ستؤسس في نفس السنة الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، بالإضافة إلى جماعات أخرى انضمت إلى الحزب الجمهوري (جماعة ولد مرزوق وجماعة ببها ولد أحمد يوره) (ولد أحمد سالم ، 2004).
في سنة 1994 حدث انشقاق جديد في حزب اتحاد القوى الديمقراطية المعارض نتج عنه انفصال حركة الحر وحركة القوميين الزنوج (ستؤسسان عام 1995 حزب العمل من أجل التغيير) كما انفصلت عنه أيضا مجموعة الشباب المعروفة بحركة الديمقراطيين المستقلين وانضمت إلى الحزب الجمهوري الحاكم، وقد أصبح أساس اتحاد القوى الديمقراطية اليساريون (الحركة الوطنية الديمقراطية) والإسلاميون.
تشكيل أطر الحر من الحراطين وهم العبيد السابقين لمجموعة البيظان الحاكمة لحزب العمل من أجل التغير وتحالفه مع الزنوج في ذلك أمر أثار حفظية السلطة الحاكمة خصوصا أن قيادات الحر حاولت التوسط بين الزنوج ونخبة البيظان من الناصرين القريبين من السلطة في أحداث 1989 العرقية، وخشت من تحالف الحراطين مع الزنوج خصوصا أنهم يطرحون طرحا ثوريا على النظام الاجتماعي التقليدي وحلوا حزب العمل من أجل التغير سنة 2002 بعد ان حقق نتائج لا بأس بها في انتخابات 2001، مما أدى بنخب الحر (الحراطين) أن يتحالفوا مع الناصرين وينضموا لحزب التخالف الشعبي مقابل تنازل الناصرين للرئاسة لهم (ولد بيْ، 2021).
لم تتوقف التوترات والتضاربات على هذا الحد فقد عرف حزب اتحاد القوى الديمقراطية أزمة خانقة بعد ما انضمت إليه مجموعة الناصريين المنسحبين من الحزب الجمهوري الحاكم حيث عارضت انضمامهم بعض مكونات الحزب وخاصة “الحركة الوطنية الديمقراطية” فانشطر الحزب إلى شطرين شطر برئاسة أحمد ولد داداه ومعه أساسا الإسلاميون والناصريون وشطر برئاسة محمد ولد مولود ويضم أعضاء “الحركة الوطنية الديمقراطية” ذوي الميول الشيوعي (ولد أحمد سالم ، 2004) أما الشطر الذي ترأسه أحمد ولد داداه فقد ضم معظم أنصار أخوه الرئيس الأسبق للبلاد ولا زال حزبهم إلا حد الساعة قائما “تكتل القوى الديمقراطية”، والآخرون شكلوا حزب اتحاد قوى التقدم[5].
أما الإسلاميون فقد كانت حركاتهم السياسية محظورة منذ ظهورها أول الأمر في فترتي الحكم الشمولي والاستثنائي (منتصف السبعينيات من القرن الماضي) إلى غاية 2007، على الرغم من أنهم في جانبهم الوسطي حاولوا دوما أن يمتزجوا في إطار حركات وتنظيمات حزبية أخرى من أجل ممارسة السياسية في كيان سياسي معترف به مثل حزب تكتل المنبثق من حزب اتحاد القوى الديمقراطية الوعاء الأولي لمختلف الحركات والحساسيات السياسية، وقد جاءت في رؤية حزبهم الذي اعترفت به الدولة وتأسس 2007 (تواصل) أن ميلاد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) في 20 رجب 1428 الموافق الثالث من أغسطس 2007 جاء تتويجا لمسيرة حافلة من التضحيات والنضال السياسي والمدني، وامتدادا طبيعيا بحكم المنطلقات والمواقف والخيارات لحركات الإصلاح والتجديد التي عرفتها مسيرة هذا الشعب بكل مكوناته، من دعوات إصلاحية مشهودة وجهود لأئمة وعلماء عاملين أثروا الساحة الثقافية والعلمية في الداخل والخارج وشكلوا جميعهم مصدر فخر لروح التضحية والجهاد وقيم العزة التي حركت أبطال المقاومة الوطنية غيرة على عقيدتهم أن تمس وصونا لكرامة وطنهم أن يدنس وذودا عن حماه أن يداس، (التجمع الوطني للإصلاح والتنمية , تواصل;، 2017) وقد حلّ الحزب منذ تأسيس وتواصل نشاطه الحزبي في المرتبة الثانية في النيابيات الموريتانية طوال فترتين انتخابيتين، انتخابات 2014 التشريعية والنيابية و2018.
خلال تلك الفترة التي تأسس فيها حزب تواصل الإسلامي تأسست أيضا حركة حزبية أخرى من رحم حركة عسكرية قادت انقلاب فاشل في 8 يونيو 2003 بموريتانيا تزعمه صالح ولد حننه تمزج في أدبياتها بين التوجه القومي الناصري والتوجه الإسلامي، سميّ الحزب “حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم)، ويبدو أنه استحضر المحاولة الانقلابية في ديباجته التأسيسية حيث جاء فيها، أن الآمال في التغيير والإصلاح والتي أنعشها انقلاب الثالث من أغسطس لم تتحقق بالكامل، (حزب الاتحاد والتغيير, حاتم;، 2008) حاولت هذه الحركة السياسية كما جاء على لسان رئيسها (صالح ولد حننه) أن تجمع في تأسيسها بين الإسلامين وبينهم في حزب لم تعترف السلطات به، وهو ما أدى إلى دعم الإسلامين لهم في انتخابات 2006 النيابية التي تمت في ظل حكم استثنائي آخر نتج عن انقلاب على الرئيس معاوية ولد الطايع على الرغم من أنه لم يمكث في الحكم كما فعل انقلابيوا 1978[6].
شكلت هذه الحركات أبرز المؤسسات الحزبية للدولة الموريتانية في السنوات الأخيرة، وكانت كلها أو جلها تنشط من موقع المعارضة للسلطة على الرغم من أنها لم تكن الوحيدة بسبب الأساس الذي من خلاله شرعت الدولة الحركة الحزبية في موريتانيا حيث لم تحدد الدولة عددا معينا للأحزاب التي يمكن أن تنشط، لذلك لم تكن هذه التنظيمات وحدها بل وصلت التنظيمات الحزبية بفعل التضارب السياسي وانعدام توفر إطار أو سقف يحد الخلافات والتوافقات إلى ما يزيد على مائة حزب شاركت منهم في نيابيات 2018 الأخيرة 98 حزبا سياسيا يمثلون كافة الطيف السياسي في البلد يتنافسون على كسب أصوات مليون و 400 ألف و663 ناخبا، مسجلين على اللائحة الانتخابية، (الوكالة الموريتانية للأنباء، 2018) وبعد انتهاء المنافسة الانتخابية أعلنت وزارة الداخلية في بداية مارس من سنة 2019 نزع الاعتراف من 76 حزبا سياسيا من أصل 105 والإبقاء على 28 حزبا حزب مقتضيات الدستور الموريتاني.
- الفضاء السياسي الموريتاني محاولة للفهم والتأويل.
طبعا من أجل فهم الحركة السياسية بموريتانيا لا بد من استعراض السياق العام لها منذ تأسيس الدولة إلى حد الساعة، أي من التعدد الذي فرضته ظروف التمثيل في البرلمان الفرنسي قبل الاستقلال مما شكل بداية ظهور الحركة السياسية في المجتمع الموريتاني، ثم مرحلة الحكم الشمولي أو تأميم الفضاء السياسي من أجل كسر شوكة المجتمع التقليدي على حساب الدولة، والحكم الاستثنائي الذي ظهر فجأة وصار يبحث عن مسوغ شرعي ضمن سياق من التضارب والصراع على مستوى النخبة العسكرية أدى إلى حدوث انقلابات داخل انقلابات قبل الوصول إلى مرحلة التعدد الحزبي الذي فتحت الدولة بمقتضاها المجال السياسي أمام الحركات الاجتماعية والإيديولوجية بموريتانيا وما نتج عن ذلك من صراعات وتوترات تجسدت في عدم السيطرة على الكم الحزبي الهائل وتمثل في واقع الهجرات السياسية داخل الكيانات الحزبية.
على الرغم من ان المصوغ الذي حافظت من خلاله السلطة على ما يعرف بأحزاب الأغلبية والمُتمثلة في معظم الأحزاب غير المعروفة هو أنها أحزاب الأغلبية الحاكمة، أي أن عدد الأحزاب التي تناصر النظام أكثر من الأحزاب التي تعارضه، وبات هذا هو المشهد المتجسد في السلطة السياسية المُدمقرطة حتى اللحظة، الأمر الذي سهل اعتراف الدولة بأي ورقة تكثر جانب الأغلبية على حساب جانب المعارضة، في ذات الوقت الذي بقيت فيه الأحزاب المعارضة المنبثقة من الحركات الاجتماعية والأيديولوجية التي أطّرت الفعل السياسي محصورة في خندق المعارضة على ما يعتيرها هي ذاتها من اختلافات ومسوغات الخلاف.
إن ولد المشهد السياسي تتحدد معالمه من خلال ثنائية المناصرة والمنافرة، المتجسدان في الصراع وتدوير الصراع، وهو نفسه كان يحدث في سياق تدبير العنف السياسي بالإمارات التقليدية حيث يتعرض عبد الودود ولد الشيخ في أطروحته لنموذج من الصراع الدموي في إمارة اترارزة حيث تم اغتيال محمد لحبيب أمير اترارزة، الذي اغتيل سنة 1277هـ 1860م عبر أبناء أخوته محمد لحبيب ولد أعمر ولد المختار ولد بوحبيني ولد أعمر ولد المختار وأحمدو الليكاط وأعل خملش، حيث قاد عملية الاغتيال سيد أحمد أعل خملش الذي كان مرشحا للإمارة من بعد محمد لحبيب من طرف أنصاره، غير أن ولد الأمير سيد ولد محمد لحبيب الذي كان مستهدفا مع أبيه نجا بأعجوبة من هذه المؤامرة لأنه كان غائبا عن “الحلة”[7] وقت اغتيال أبيه ليبدأ في الغد تنظيم عملية انتقامية ضد قتلة أبيه الذين لجأوا إلى أهل السيد من أولاد أحمد بن دمان (ould cheikhe , 1985)، ليلبس بعد انتصاره السروال الأبيض ويقود إمارة اتررزة بصفة فردية مدة عشرة عشر سنوات عرفت خلالها الإمارة كما يقول ولد الشيخ سلما داخليا وخارجيا (ould cheikhe , 1985).
يوضح ولد الشيخ أن سيدي حكم بالاعتماد على أخواله أهل التونسي من أولاد أحمد بن دمان، حيث بقيّ شيخهم سيد أحمد ولد عثمان ولد إبراهيم اخليل مستشاره المقرب دوما، وكانت علاقته بأخيه غير الشقيق أعل ولد جمبت[8] أحسن من علاقته بإخوته الآخرين غير الأشقاء “أولاد فاطمة” الذين أنجبهم محمد الحبيب من زواجه الثاني في أولاد دمان وبقوا قطبا معارضا للإمارة (ould cheikhe , 1985)، وأطلق عليهم عبد الودود أولاد فاطمة حيث قاموا بالاعتماد على أخوالهم وبمساعدة وزير محمد الحبيب السابق أخيارهم بالثورة على أخيهم.
وفي سنة 1288هـ 1871م أغتيل الأمير سيد ولد محمد الحبيب ومستشاره سيد أحمد ولد عثمان ولد إبراهيم اخليل من طرف أولاد فاطمة وأعلن الأخ الأكبر منهم المسمى أحمد سالم نفسه أميرا، وفي المقابل أعلن ولد جمبت معارضته لإمارته وقد استفاد في ذلك من نقمة أولاد أحمد بن دمان على أولاد فاطمة لخأولتهم من أولاد دمان، وشكل جيشا من أولاد أحمد بن دمان ومن اترارزة الكحل، وأغار به على الأمير أحمد سالم وشيعته التي تتكون أساسا من أولاد دمان، وبعد هزيمة طرف أحمد سالم وأخواله في معارك متعددة وقتل الأمير أحمد سالم، أصبح أعل أميرا بينما واصل أخوة أحمد سالم المتبين ثورتهم على أخيهم (ould cheikhe , 1985).
وكأن القاعدة الأساسية التي تحكم المنطق السياسي هو التغلب والمناصرة ثم المنافرة وتلك قيم تم استنباطها واستحضارها في المشهد السياسي الحالي للدولة منذ تأسيسها ضمن غياب رؤية تنظيمية وسقف ثابت يؤطر الفعل السياسي بموريتانيا، فتجسدت ثنائية التنافر والمناصرة في المجال السياسي بالترحال السياسي والخروج من تنظيم وخلق آخر بديل عنه من أجل تصدر المشهد داخله، تماما كما حدث مع حزب اتحاد القوى الديمقراطية الذي تعرضنا له آنفا، والذي يعتبر أول كيان حزبي ضم مختلف الحساسيات الوطنية، برحيل نشطاء حركة الحر، وتأسيسهم حزبا (حزب العمل من أجل التغير) ثم اليساريون وتكتل والإسلاميون.
أما في المجال الحركات المحكومة بالحس الإيديولوجي والتي عبأت الشارع أيام الحكم الشمولي خلال تأميم الرئيس الأسبق المختار ولد داداه للمجال السياسي بإدماج مختلف التشكيلات السياسي في حزب الدولة (حزب الشعب) فإن نشاطها في المجال الحركي أو تعبئتها فيه كانت أقوى من تعبئتها في المجال التنظيمي الحزبي، حيث ركزت الحركة اليسارية التي نشأت خلال اضراب العمال 1966 في طرحها اليساري على التراتب الطبقي للفئات الدنيا من المجتمع والدفاع عنها دون تميز عرقي ولا شرائحي من مختلف الشرائح وهو ما عارضته حركة الحر التي كانت منبثقة منهم في الغالب وأرادوهم أن يركزوا على مشكل الحراطين كعبيد وعبيد سابقين فقط (ولد الدده، 2020)وما حققته الحركة اليسارية في نشاطاتها الحركية أقوى من ما حققته في نشاطاتها الحزبية.
أما الحركة القومية بشقيها البعثي والناصري، فعلى الرغم من انبثاق أحزاب منها، مثل حزب التحالف الشعبي والطليعة أولا ثم الصواب آخرا، فإن تعبئتها الحزبية كانت أضعف فلم لم تنتج عنها مشاركة سياسية قوية في هيئات الدولة التشريعية، إلا بالتحالف مع الأحزاب المنبثقة من الحركات التحررية أو الحقوقية الحرطانية، مثل تحالف الحر واندماجهم في حزب التحالف الشعبي التقدمي في بداية القرن الواحد والعشرين 2003 حيث تنازل الناصريون لزعيم الحر وقتها مسعود ولد بلخير عن رئاسة الحزب[9]، وكذلك في اتفاق رئيس حركة إيرا بيرام ولد أعبيدي مع حزب الصواب ذا التوجه البعثي، مما تخلل عنه دخول عدد من أعضاء الحزب البرلمان إلى جانب قادة حركة إيرا التي حملت مشعل الحراك الحرطاني منذ 2012 وتصدر زعميها المشهد باعتباره زعيما جديدا للحراطاين بدلا من زعيم الحر القديم مسعود.
ذلك أن الحركة القومية التي أطّرت العقل السياسي الموريتاني في بداية عهد الدولة ولدت أرضية خصبة لتنظيراتها في ميولات العامة ومشاعرهم، كانت أفكارها في الأصل متبناة من طرف العامة والدولة معا، حيث ركزت موريتانيا منذ تأسيسها في دساتيرها على الهوية العربية والإفريقية، مما جعل الأفق السياسي يسدّ أمام التنظيمات الحزبية في تحقيق ما حققت حركاتها الإيديولوجية التي عبأت الشارع في سبعينيات القرن المنصرم.
أما المعنى الذي يمكن استنباطه من الحركة الإسلامية منذ ظهورها في منتصف سبعينيات القرن المنصرف إلى غاية ممارستها السياسة بخلق إطار سياسي معترف به حقق في السنوات الأخيرة في الانتخابات التشريعية الفائتة، فقد تبنى الجناح السياسي مثل الديمقراطية التعددية وعملوا على تطوير عقيدة وسطية مع إدانة التطرف والتشدد الديني، بل إن البعض منهم أجرى مراجعات إيديولوجية عميقة مكنتهم من إعادة النظر في مكانة المرأة والإيمان والالتزام الحزبي (ould Ahmed salem, 2013) ومن خلال تطبيقات هذا الشعار في الحياة السياسية بما يقتضيه من رؤية وسطية تنفر من دعوات الإسلام الجهادي وتمزج بين الدين والتجديد حاولت الحركة الإسلامية أن تبني معتقداتها السياسية في جميع الأوطان الإسلامية وفي موريتانيا أيضا.
حاولت الحركة أيضا التجديد أيضا في طبيعة الممارسة الإسلامية بكسر شخوص الإسلام الصوفي وتراتبيته وقدسية مشايخ الطرق الصوفية ببناء ينحو منحى بناء ذهني جديد في تكون الإيديولوجية الإخوانية التي تأسست في مصر منبع تحرك شخوص وسياج معقوليته ورهان التعبئة السياسية لهم أيضا، وقد نجحوا خلال خروجهم من المرحلة الحركية السرية التي كانت تطالهم فيها عوامل اللبس مع الحركات الجهادية، إلى المرحلة الحزبية بانتظامهم وفق قواعد الإيديولوجية في إطارهم الحزبي (تواصل)، على العلم أن التعبئة المضادة قد نجحت في السنوات الأخيرة تنفيرا من طرحهم بتذكريهم بمزاجهم الأصلي المتشدد وبرفض أن يكونوا هم المتكلمون الرسميون باسم الدين[10].
إن المبدأ الأساسي الذي يمكن من خلال تفسير ثنائية التنافر والتناصر بالمشهد السياسي الموريتاني، ودون أن نرجح على أحزاب الدولة التي لم تنتج من حركات فقط كانت فضاء تجمع فيه السلطة مناصريهم وتعبئ بالقوة وبغيرها الشارع خدمة لأهدافها، والذي يمكن أن يفسر أو يقدم المعنى الخفي للترحال السياسي هو الرغبة دوما في (الحظرة) فمن أجل الحصول عليها خرج أعضاء الحر من اليسارين (ولد الدده، 2020)، وتضاربت المواقف وتفاقمت الصراعات في حزب اتحاد القوى الديمقراطية من أجل فسح المجال لحظرة أطر جدد وخلق قيادات سياسية جديدة في وسط ينعدم لسقف انعدامه لأي مبدأ يحده.
الخاتمة.
كتحقيق للفرض الأولي يمكن اعتبار أن الحركة السياسية في موريتانيا على الرغم من توفر شروط ولادتها بفعل السيطرة الكولونيالية فإنها خلقت جيلا من متوسطي المكانة نافس الشيوخ والأمراء ضمن الفضاءات السياسية الحزبية الوليدة من أجل التمثيل في البرلمان الفرنسي قبل ولادة الدولة، وهي مسلمة ظهرت في قائمة الأحزاب التي أسست بعد 1946 وما اعتراضها من تضارب وصراع ودعم، ما جعل المشايخ القبلية في صف ضد الساسة التقدمين وقتها من أجل المحافظة على مكانتهم وسط متغيرات تتحدد بالتعارض والصراع والرغبة في الحظرة أكثر من أي شيء آخر.
ثم إن مسوغات تأميم المجال السياسي كانت أيضا من أجل تثبيت مكانة تلك النخبة التقدمية على حساب مكانة الزعماء التقليدين، وفتح المجال السياسي لحزب وحيد هو حزب الدولة، من أجل امتصاص التعارضات والتوترات الاجتماعية، غير أن ذلك الفعل خلق في حد ذاته توترا على المستوى الحركي والإيديولوجي تمثل في ظهور الحركات الإيديولوجية بفعل إلتقاء روافد الداخل مع الخارج الأمر الذي جعل الاجتماعي/التقليدي يتآكل أمام التحديث، أو بعبارة أخرى ما جعل الزعامات التقليدية يحاكون المستجدات من أجل المحافظة على مكانتهم في الدولة وسط تنامي الحركات الإيديولوجية التي أصبحت بفعل فاعل تمثل النخبة التقدمية وقت حظر التعددية الحزبية بينما وجدت الزعامات التقليدية مسوغات البقاء في حزب الدولة.
وهو المكان الذي حافظت عليه في كل المراحل السياسية التي شهدتها الدولة (الحكم الشمولي والاستثنائي والمُودمقرط) من خلال حجز مكانها دوما في مقاعد حزب السلطة الذي تلون عبر مختلف المراحل الحزبية من الشعب إلى الهياكل (هياكل الجماهير) التي ظهرت في فترة حكم ولد هيداله (الحكم الاستثنائي) إلى الفترة المُودمقرطة بين الحزب الجمهوري وحزب عادل فترة سيدي ولد الشيخ عبد الله وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية في الفترة الحالية.
ليبقى المجال الآخر متروكا لأصحاب الرتب الدنيا ومن يبتغي (الحظرة) من خلال الانخراط في المؤسسات الحزبية واعتناق السياسية كحل لمشكل عدم التواجد، الأمر الذي تعددت من خلاله الأوجه ومقاربات التنافر والتناصر في الجانب الآخر (المعارضة) ثم أحزاب الورق كما أشرنا سابقا.
Bibliographie
“el hor”. (s.d.). organisation pour la libération et l’émancipation des haratines “el hor”, charte constitutive.
jean louis, b. (s.d.). Le système politique Mauritanien. I.
ould Ahmed salem, z. (2013). Prêcher dans le désert islam politique et changement social en Mauritanie. paris: éditions KARTHLA.
ould cheikhe , A. (1985). Nomadisme Islam et Pouvoir politique dans la société maure précoloniale (XI-XIXè s) Essai sur quelques aspects du tribalisme, Thèse de doctorat( Sociologie). paris: 3t Paris V.
إسراء جمال رشاد عرفات . (2017). الحركات الاحتجاجية ودورها في مخرجات التغير السياسي العربي- دراسة مقارنة بين مصر وتونس والبحرين. جامعة النجاح الوطنية . نابلس ، فلسطين .
افرانسيس دي شاسيه . (2014). موريتانيا من سنة 1900 إلى سنة 1975. (ولد بوعليبة الدكتور محمد، المترجمون) نواكشوط، موريتانيت: دار النشر جسور 1.
افرانسيس دي شاسيه . (بلا تاريخ). موريتانيا من سنة 1900 إلى سنة 1975. (ولد بوعليبة الدكتور محمد ، المترجمون) نواكشوط، موريتانيا: دار النشر جسور 1.
التجمع الوطني للإصلاح والتنمية , تواصل;. (24 12, 2017). الرؤية المرجعية، نواكشوط،. الرؤية المرجعية لحزب تواصل، 1. نواكشوط.
الخليلو ولد الدده. (26 11, 2020). مقابلة أعدها (الباحث) معه تمت من أجل استكمال أطروحة دكتوراه، بعنوان: الحركات الهويّاتية والسلطة في موريتانيا حركات الحراطين أنموذجا. (نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم اليساري، المحاور) نواكشوط.
الساموري ولد بي . (23 02, 2021). مقابلة من أجل استكمال أطروحة الدكتوراه بعنوان: السلطة والحركات الهويّاتية في المجتمع الموريتاني – حراك الحراطين أنموذجا. نواكشوط.
الساموري ولد بيْ. (23 02, 2021). مقابلة أعدها (الباحث) معه تمت من أجل استكمال أطروحة دكتوراه، بعنوان: الحركات الهويّاتية والسلطة في موريتانيا حركات الحراطين أنموذجا. نواكشوط.
السيد ولد أباه ، و وآخرون. (1995). الدولة والقوى السياسية. بيروت، لبنان : مركز دراسات الوحدة العربية 1.
الوكالة الموريتانية للأنباء. (17 18, 2018). انطلاق الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع فاتح والـ 15 سبتمبر 2018 في عموم التراب الوطني. خبر.
بداوي محمد سفيان. (2019-2020). الحركات الاجتماعية. المسيلة، جامعة محمد بوضياف، الجزائر.
بهاء الدين مكاوي . (2018). مفاهيم سياسية معاصرة – نحو وعي سياسي متقدم. المكتبة الوطنية . الخرطوم ، السودان .
جورج بلاندييه . (2007). الأنثروبولوجيا السياسية. (2، المحرر، و المصري علي، المترجمون) بيروت: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
حزب الاتحاد والتغيير, حاتم;. (03 05, 2008). الإعلان السياسي. نواكشوط.
سيد أحمد ولد أحمد سالم . (03 10, 2004). المسار السياسي الموريتاني الحديث. الجزيرة نت.
عبد الرحمن حرمه ببانا العلوي. (2014). الجيش والسلطة في موريتانيا. مركز الصحيفة للدراسات الاستراتيجية 1.
غيرتز، كليفورد. (2009). تأويل الثقافات. (بدوي الدكتور محمد، المترجمون) بيروت: المنظمة العربية للترجمة 1.
مجد الدين بن يعقوب الفيروز أبادي . (2008). القاموس المحيط. الطبعة الأولى. دار الحديث القاهرة ، مصر .
محمد الأمين ولد سيدي باب ، و صديقي محمد الأمين . (2019). الإصلاحات السياسية والدستورية في موريتانيا: الواقع والتحديات. ، المجلة الإفريقية للدراسات القانونية والسياسيةالمجلد 03، صفحة 13.
محمد فقهي . (2014-2015). دروس في علوم السياسة. فاس، جامعة سيد محمد بن عبد الله.
محمود ولد عبد الرحمن . (27 04, 2019). مقابلة أعدها (الباحث) معه تمت من أجل استكمال أطروحة دكتوراه، بعنوان: الحركات الهويّاتية والسلطة في موريتانيا حركات الحراطين أنموذجا. الأمين العام المساعد لحزب التحالف الشعبي والعضو المؤسس لحركة الحر. نواكشوط.
[1] – اخترنا عبارة “المودمقرط” لأن التعددية الحزبية التي نتجت عن دستور 1991 لم تفرزها طبيعة سياسية واجتماعية داخلية، وإنما تمت نتيجة لإملاءات خارجية في الغالب، وهو جعل السلطة تحاول تكيف الواقع مع متطلبات الاقتراع والتعدد.
[2] – الحظرة، كلمة حسانية تعني المشاركة التي تحمل معنى مادي.
[3] – حكمت موريتانيا من طرف الجيش جراء أول انقلاب 1978 أزاح الرئيس المؤسس، المختار ولد داداه عن الحكم وحكم في مكانه قائد أركان جيشه العقيد مصطفى ولد محمد السالك، وتبادل على السلطة منذ ذلك الحين، وحتى اعتماد دستور 1991 عدة قادة من الجيش في إطار صراعات داخل المؤسسة العسكرية أفضت إلى انقلابات أخرى داخل الانقلاب الأولي.
[4] – لا يزال موجودا إلى حد الساعة وترأسه وزيرة سابقة في عهد ولد الطايع، “منتاته بنت حديد” ومع أنه كان في الفترة الأولى من الانفتاح الديمقراطي أكبر الأحزاب في موريتانيا، وطيلة حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، إلا أن جميع كوادره انسحبت عنه بعد الإطاحة بحكم رئيسه 2005، وبات أشبه بالبيت المهجور حتى أنه عجز عن أن يوصل رئيسته لسدة البرلمان في انتخابات 2018 التشريعية.
[5] – كلا الحزبين “حزب اتحاد قوى التقدم” الذي يرأسه محمد ولد مولود ويضم أعضاء الحركة الوطنية الديمقراطية ذات التوجه اليساري، والتي نشأت بوادرها منذ 1966 في إضرابات العمال بموريتانيا، وحزب “تكتل القوى الديمقراطية” والذي يرأسه أحمد ولد داداه شقيق الرئيس الأسبق للبلاد المختار ولد داداه، لا زالا إلى حد الساعة يعتبران من أبرز أحزاب المعارضة بموريتانيا، ومتقاربان في وجهات النظر دوما، تجسد ذلك التقارب في تحالفهما في انتخابات 2019 الرئاسية بعد أن انشطرت المعارضة بفعل الاختلافات الإيديولوجية والحركية الاجتماعية في أحزابها.
[6] – نقصد المحاولة الانقلابية التي جاءت بمجلس عسري اطلق على نفسه المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية 03 أغسطس 2008 برئاسة الرئيس الموريتاني الأسبق أعل ولد محمد فال والذي قاد مرحلة انتقالية سلم بعد السلطة لأول رئيس مدني منتخب يحكم موريتانيا بعد انتخابات 2007 الرئاسية، هو الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
[7] – الحلة أو المحصر، وهو تجمع موسمي تكون في الإمارة، وهو اسم عرض بنمط التقري بنصب الخيام لبيظان الصحراء الكبرى، وينتجعون حسب الفصول ويغيرون مواضع سكانهم تبعا لذلك.
[8] – جمبت: اسم أم وهي أمةٌ من أمراء ؟والو” بالسنغال
[9] – ولد بيْ، الساموري: مقابلة سبق ذكرها.
[10] – في الانتخابات النيابية والتشريعية التي نظمت في موريتانيا أغسطس 2018 قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في مهرجان كان يعبئ فيه لحزبه (حزب الاتحاد من أجل الجمهورية- حزب الحاكم- ) أن ميّالين للعنف وأنهم عندما يفشلوا سياسيا يتوجهون للعنف.